قاسى الفلسطينيون، ضمن أشياء كثيرة قاسوها، من خطاب الكراهية، حد تعرضهم إلى مجازر وإزهاق أرواح وتنكيل ممنهج. ولئن كان أرباب التربية الإعلامية قد التفتوا مؤخرا إلى مصطلح خطاب الكراهية، محذرين من عواقبه، فإن الفلسطينيين قد اختبروه وعاشوا نتائجه قبل ذلك بعقود طوال.اضافة اعلان
في العام 1982، جاهر “الشاعر” سعيد عقل بكراهيته للفلسطينيين، في لقاء متلفز، ما تزال مقاطعه موجودة حتى اليوم على “يوتيوب”، داعيا شارون إلى تخليص العالم منهم ومتمنيا لو كان بوسعه فعل هذا بيديه. توالت موجات خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين آنذاك، تارة تهددهم بتحويل مخيماتهم إلى” حدائق حيوان وملاعب تنس”، وتارة تعتبرهم “شعبا فائضا عن حاجة المنطقة”، لتفضي إلى مجزرة صبرا وشاتيلا، التي أعقبتها مجازر أكثر بشاعة تحت مسمى “حرب المخيمات”.
إبان غزو العراق للكويت في مطلع التسعينيات، قاسى فلسطينيون كثر من جرائم الكراهية التي أعقبت خطاب الكراهية متعالي الوتيرة آنذاك؛ بسبب موقف القيادة الفلسطينية المنحاز إلى النظام العراقي. ما أفضى بدوره إلى قتل كثير واعتداءات وصلت حد نهب الممتلكات والتعذيب والتنكيل في صفوف المغتربين الفلسطينيين.
إبان الأزمة السورية، نُكِّل بالفلسطينيين في مخيم اليرموك أيّما تنكيل، وفي كل أزمة كان “الحيط الواطي” دوماً هو الفلسطيني وتجمّعاته السكانية في الدول العربية، وكم من جريمة كراهية وُجّهت ضده، وكم من رزق تم قطعه بمجرد أن تُدلي القيادة الفلسطينية بتصريح صحفي لا يعجب دولة عربية ما، بل أُلقيَ ذات مرة بفلسطينيين في الصحراء؛ عقاباً من النظام الليبي آنذاك على رغبة القيادة الفلسطينية خوض مخاض السلام. ما تزال مقاطع الفيديو موجودة حتى اللحظة لفلسطينيين يرجفون بردا في خيام على الحدود الليبية؛ لليّ ذراع المنظمة! كان ذلك خير تجسيد للمقولة الساخرة “نحب فلسطين، ونكره الفلسطينيين”.
كان الفلسطيني يتحسّس رقبته بخوف كلما نشبت أزمة عربية؛ ذلك أنه أول المتضررين على الأغلب.
منذ أعوام قليلة، بات الذباب الإلكتروني نشطا في تأجيج مشاعر الكراهية ضد الفلسطينيين عبر فضاءات منصات التواصل الاجتماعي، وغدا الفلسطيني في مرمى نيران صديقة أو عدوة، لا فرق، وصار يخشى من التصريح بهويته الحقيقية؛ مخافة تعرضه إلى مكروه ما، نفسيا كان أو جسديا.
ولعل أكثر ما قاساه الفلسطيني إلى جانب التنكيل الممنهج، والمستمر، تهمة بيع أرضه للاحتلال، وهو ما تنفيه المراجع المنصفة، عربياً وعالمياً، بل إن أرشيف كيان الاحتلال نفسه يشهد على حجم الجرائم التي أُلحِقت بالفلسطينيين، مجبرة إياهم خوفا ورعباً على مغادرة قراهم ومدنهم، ويشهد في الوقت ذاته كم استمات الفلسطينيون في الدفاع، بكل ما بين أيديهم من إمكانيات شحيحة.
توعية حول خطاب الكراهية لا بد أن يُباشَر بها جدياً، بدءا من استحضار التجارب التاريخية التي أفضى فيها خطاب الكراهية إلى كوارث إنسانية، وليس انتهاءً بتذكير العالم أجمع أن الفلسطيني لم يبع أرضه، وأنه أزهر حيثما عصفت به الرياح، وأنه شعب كباقي شعوب الأرض يخطئ ويصيب وأن فيه الصالح والطالح، وأنه من غير المقبول إنسانيا وقوميا أن يُنكّل به معنوياً وجسدياً تحت أي ذريعة كانت.
قبل بضعة أشهر، كنت أعد جلسة توعوية لعدد من الإعلاميين من جنسيات عربية وأجنبية، حول خطاب الكراهية المزمن ضد الفلسطينيين. لكن، يبدو أن الطبيب يفلح في أي عملية جراحية إلا ما يتعلق بأحد ذويه، وأن المربي يتعامل بحزم مع طلبته بيد أنه يقف مرتبكا أمام طفله، كذلك هو المتحدث: يفلح في الحديث عن مآسي غيره، بيد أنه حين يتحدث عن أهله ترتجف نبرة صوته وترتج يداه؛ لشدة الشجن والإحساس بالعجز.
في العام 1982، جاهر “الشاعر” سعيد عقل بكراهيته للفلسطينيين، في لقاء متلفز، ما تزال مقاطعه موجودة حتى اليوم على “يوتيوب”، داعيا شارون إلى تخليص العالم منهم ومتمنيا لو كان بوسعه فعل هذا بيديه. توالت موجات خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين آنذاك، تارة تهددهم بتحويل مخيماتهم إلى” حدائق حيوان وملاعب تنس”، وتارة تعتبرهم “شعبا فائضا عن حاجة المنطقة”، لتفضي إلى مجزرة صبرا وشاتيلا، التي أعقبتها مجازر أكثر بشاعة تحت مسمى “حرب المخيمات”.
إبان غزو العراق للكويت في مطلع التسعينيات، قاسى فلسطينيون كثر من جرائم الكراهية التي أعقبت خطاب الكراهية متعالي الوتيرة آنذاك؛ بسبب موقف القيادة الفلسطينية المنحاز إلى النظام العراقي. ما أفضى بدوره إلى قتل كثير واعتداءات وصلت حد نهب الممتلكات والتعذيب والتنكيل في صفوف المغتربين الفلسطينيين.
إبان الأزمة السورية، نُكِّل بالفلسطينيين في مخيم اليرموك أيّما تنكيل، وفي كل أزمة كان “الحيط الواطي” دوماً هو الفلسطيني وتجمّعاته السكانية في الدول العربية، وكم من جريمة كراهية وُجّهت ضده، وكم من رزق تم قطعه بمجرد أن تُدلي القيادة الفلسطينية بتصريح صحفي لا يعجب دولة عربية ما، بل أُلقيَ ذات مرة بفلسطينيين في الصحراء؛ عقاباً من النظام الليبي آنذاك على رغبة القيادة الفلسطينية خوض مخاض السلام. ما تزال مقاطع الفيديو موجودة حتى اللحظة لفلسطينيين يرجفون بردا في خيام على الحدود الليبية؛ لليّ ذراع المنظمة! كان ذلك خير تجسيد للمقولة الساخرة “نحب فلسطين، ونكره الفلسطينيين”.
كان الفلسطيني يتحسّس رقبته بخوف كلما نشبت أزمة عربية؛ ذلك أنه أول المتضررين على الأغلب.
منذ أعوام قليلة، بات الذباب الإلكتروني نشطا في تأجيج مشاعر الكراهية ضد الفلسطينيين عبر فضاءات منصات التواصل الاجتماعي، وغدا الفلسطيني في مرمى نيران صديقة أو عدوة، لا فرق، وصار يخشى من التصريح بهويته الحقيقية؛ مخافة تعرضه إلى مكروه ما، نفسيا كان أو جسديا.
ولعل أكثر ما قاساه الفلسطيني إلى جانب التنكيل الممنهج، والمستمر، تهمة بيع أرضه للاحتلال، وهو ما تنفيه المراجع المنصفة، عربياً وعالمياً، بل إن أرشيف كيان الاحتلال نفسه يشهد على حجم الجرائم التي أُلحِقت بالفلسطينيين، مجبرة إياهم خوفا ورعباً على مغادرة قراهم ومدنهم، ويشهد في الوقت ذاته كم استمات الفلسطينيون في الدفاع، بكل ما بين أيديهم من إمكانيات شحيحة.
توعية حول خطاب الكراهية لا بد أن يُباشَر بها جدياً، بدءا من استحضار التجارب التاريخية التي أفضى فيها خطاب الكراهية إلى كوارث إنسانية، وليس انتهاءً بتذكير العالم أجمع أن الفلسطيني لم يبع أرضه، وأنه أزهر حيثما عصفت به الرياح، وأنه شعب كباقي شعوب الأرض يخطئ ويصيب وأن فيه الصالح والطالح، وأنه من غير المقبول إنسانيا وقوميا أن يُنكّل به معنوياً وجسدياً تحت أي ذريعة كانت.
قبل بضعة أشهر، كنت أعد جلسة توعوية لعدد من الإعلاميين من جنسيات عربية وأجنبية، حول خطاب الكراهية المزمن ضد الفلسطينيين. لكن، يبدو أن الطبيب يفلح في أي عملية جراحية إلا ما يتعلق بأحد ذويه، وأن المربي يتعامل بحزم مع طلبته بيد أنه يقف مرتبكا أمام طفله، كذلك هو المتحدث: يفلح في الحديث عن مآسي غيره، بيد أنه حين يتحدث عن أهله ترتجف نبرة صوته وترتج يداه؛ لشدة الشجن والإحساس بالعجز.










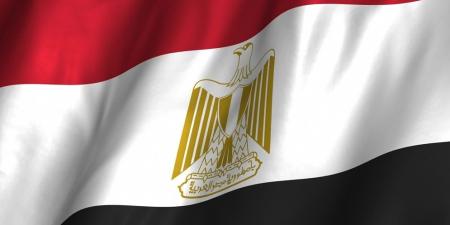



0 تعليق