عمان - أثرى المفكر العربي عبدالإله بلقزيز القارئ والمكتبة العربية بعشرات الكتب والدراسات والأبحاث التي تحفر عميقا في العقل، ورغم ذلك لم يكف، صاحب "مسالك التقدم: مداخل في الأسس والسياسات"، عن طرح الأسئلة، باستمرار، باعتبارها فعلا فلسفيا، وكل إجابة لديه كانت تفضي إلى سؤال.. وهكذا في متوالية لا تنتهي من التساؤلات لا الإجابات، مستوحيا ما قاله الفيلسوف الوجودي الألماني، كارل ثيودور ياسبرس:"الأسئلة في الفلسفة أهم من الأجوبة، إن كل جواب يصبح سؤالا جديدا".اضافة اعلان
ويرى بلقزيز، في كتابه "المتغيرات والصيرورات قراءة في معطيات عالم متحول"، الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، أن التغير قانون حاكم في المجتمع الإنساني، كما في الطبيعة، وما من شيء من ظواهر الاجتماع والاقتصاد والسياسة والمعرفة يظل ثابتا على قوام دائم، حتى وإن بلغ عمرانه من الرسوخ شأوا كبيرا، إذ سرعان ما يأتي على الثابت والراسخ حين من الدهر يتغيّر فيه ويتخذ هيئة جديدة، وإذا كان التغيّر في الطبيعة محكوما بقوانين الطبيعة، فهو في المجتمعات مرتبط بـالإرادة وبالأفعال الإنسانية؛ إذ هي من توجد له الأسباب وتهيئ له الشروط وتفرض إمكاناته على هذا النحو أو ذاك.
ومع ذلك لا تقوى الإرادة الإنسانية، دائما في الأحوال كافة، على أن تتحكم في مجرى التغير الذي تشارك في صنعه، فقد يحصل أن يجدف ضد تيارها، وأن يفرض على صنّاعه حقائق مختلفة ما توقعوها ولا قصدوا إليها حين خاضوا في أمره.
وبرؤية فلسفية فيزيائية، يؤطر بلقزيز فكرة التغيّر بالقول "كلما تواتر التغير في الواقع الإنساني، وتسارع إيقاعه، زادت فرص تنامي مستوى الفعالية الإنسانية أكثر، وذلك لما يتولّد من واقع التغير من معارف وخبرات جديدة تدخل في إعادة تأهيل قدرات الإنسان على الإبداع أكثر، وبالتالي، على صنع ظواهر جديدة في التاريخ. وهكذا ليست الفعالية الإنسانية- بماهي تجسيد للإرادة- وحدها التي تنتج الأسباب التي تزيد من إيقاع التغير وتسرّع وتائره الزمنية، وبالتالي يزداد بسرعته تراكم الظواهر الجديدة -في ميادين العلم والاقتصاد والتكنولوجيا- بل إن هذه الأخيرة سرعان ما تصبح وقودا وطاقة جديدة تشحن بها بطارية تلك الفعالية الإنسانية المنتجة لتعاود فعلها من جديد".
لكنه يقف مستدركا، "غير أن ما تبدعه الفعالية الإنسانية من معطيات مادية وظواهر جديدة، وإن كانت مما تسهل به شروط الحياة وتتسع به الخيارات في المجتمعات ولدى الأفراد، ليس دائما مما يمكن التحكم فيه وفي مساره، ولا مما يقبل استيعاب نتائجه والسيطرة علها في كل الظروف، فرب منتوج ينفصل عن منتجه ويستقل عنه بنظامه الخاص، حتى لقد يصبح في لحظة ما عبئا عليه إن لم يتحول إلى متحكم جديد في ذلك الذي أنتجه وقاد إليه الإنسان، ومن هنا تبدأ المشكلة الكبرى في الإبداع الإنساني: مشكلة الاستلاب، حيث يخرج المصنوع من سلطة الصانع، ويصير الثاني تبعا للأول: يوجهه ويسخّره، ويضرب مثلا على ذلك بالتقنية أو التقانة التي تتحول شيئا فشيئا إلى نظام يصبح الإنسان خاضعا له غير قادر على العيش من دونه، متسائلا: أليس المنتوج هنا، من يتحكم في المنتِج؟، أليس هذا أيضا من مفاعيل قانون التغير؟".
ويرى بلقزيز، أن القاعدة المألوفة في السياسات العليا للدول، أن المستقبلات التي تتغيّاها الأمم والدول لا تأتيها عفوا وبالتلقاء، وإنما تُصنع صنعا ويقع التخطيط لها، بعناية، ويواكب إنجازها القدر الضروري المطلوب من المتابعة والتصحيح والتدارك.
وهكذا يأتي التطور مراقبا ومقترنا بقدر من القصدية ومن تدخل الإرادة الإنسانية في المجرى والمسار، على النحو الذي يتولّد منه الهدف الإنساني المرغوب فيه والمحسوب.
وليس معنى ذلك أن التطور يخضع، حكما، للإرادة الإنسانية ويعدم قوانينه الموضوعية المستقلة، إذ موضوعية عوامله أمر متقرر بقوة أحكام الأشياء والظواهر والقوانين: في الطبيعة كما في العالم الإنساني والتاريخ، غير أن موضوعيته ليست دائما حتمية ولا عمياء، وإنما يتدخل عامل الإرادة الإنسانية في تكييفه وفي توجيه مساره أو في تعديل اتجاهاته أو تصويب حركته.
يقع ذلك أكثر ما يقع حين يكون التطور ذاك محكوما في الغالب بهندسة قبلية (= تخطيط) تأتي حركته تنفيذا لها، أي يكون فيها خاضعا لفعل من العقلنة الاجتماعية: السياسية والاقتصادية، وهو ما ينسحب على التقنية أو التكنولوجيا، على أهميتها، شيأت الإنسان وجردت الفعل الإنساني من كل مضمون إنسانوي، بل حولت الإنسان إلى آلة أو إلى عبد تابع للآلة، ناهيك عن تنميطها فكره وذوقه وقيمه، ناهيك عن إلغائها العمل الإنساني، تدريجيا، والاعتياض عنه بالعمل الآلي، ونواتج ذلك من بطالة وتهميش اجتماعيين وتعطيل لطاقات الإبداع الإنساني.
في كتابه، حاول المؤلف تقديم رواية نقدية عن الأوضاع العربية القائمة والمستمرة تهالكا منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، جنبا إلى جنب مع محاولة مطالعة هذه الحالة من التغير الهائل الذي يشهد عليها العالم من حولنا، رائيا ضرورة مراجعة العقائد السياسية والاقتصادية والثقافة المؤسسة لكل المسار الإنساني الحديث والمعاصر، والتي قادت إلى هذا المنوال الاجتماعي- الاقتصادي وإلى هذا النظام السياسي السائدين في العالم، وما استجرّاه من مشكلات وأزمات وحروب وتفاوتات صارخة بين البشر، مؤكدا أن هذا النظام وهذا النموذج (المنوال) شربا كأسهما المُرّة الأخيرة؛ بمناسبة جائحة كورونا التي سقطا أمامها سقوطا مدويا.
فتجربة ما سمي بـ"الربيع العربي"، في مطلع العقد الثاني من هذا القرن، وانتفاضتي شعبي السودان والجزائر، في خواتيم العقد نفسه، تطلعنا على الكم الهائل من المشكلات والأزمات التي تعتمل في الداخل الاجتماعي والسياسي للبلاد العربية، وهي التي كانت في أساس الانفجارات تلك؛ مشكلات الاستبداد السياسي، والتسلطية وخنق الحريات العامة، الفساد المالي والسياسي والإداري، الفقر والتهميش الاجتماعي، الناجمين من الافتقار الكامل إلى أي مظهر من مظاهر العدالة الاجتماعية ومن سوء توزيع الثروة، والفشل التنموي الذريع ونتائجه الاجتماعية الحادة (= تزايد الفوارق الفاحشة بين الطبقات الاجتماعية)؛ التحيُّف الفاضح في حقوق النساء والشباب، هشاشة بنى المواطنية وروابطها ممثلة في انبعاث النعرات العصبوية والأقوامية الإنقسامية.. الخ، ولقد اجتمعت هذه المشكلات، كلا أو بعضا، لتهيئ الأسباب العميقة للانفجارات الشعبية تلك، حتى بمعزل عن أي عوامل أخرى استجدت عليها، وكان لها بالغ الأثر في ما حصل خلال ما يزيد على عقد من ذلك "الربيع".
ويحذر بلقزيز، أنه ما من شيء يدعونا إلى الاطمئنان إلى وضع ملتبس كالذي نحن فيه اليوم، إلى الركون، مثلا، أو الاعتقاد أن استقرارنا قد يتأمّن عبر السير في ما نحن فيه نسير، وما اعتدنا، طويلا من عوائد من قبيل تجاهل المشكلات العميقة في اجتماعنا السياسي، أو إهمال أو لوياتها والميل إلى ترحيلها أو تأجيلها إلى أزمان مقبلة، أو إلى الركون إلى الاعتقاد في سلامة تشخيصنا للتحديات الداخلية والخارجية التي تمتحن أمن مجتمعاتنا ودولنا واستقرارها، أو من قبيل استسهال شأن بعض المطالبات التي قد تبدو لنا غير ذات قدرة على ممارسة التهديد، لمجرد أن حَمَلَتها أقلية وغير ذي بأس وشدة، متناسين أنها مطالبات لاتقوى وتعظم بقوة حَمَلَتها الداخليين، وإنما تستفحل حين يلتقطها من يلتقط من حوامل خارجية. وبكلمة لابديل لنا من يقظة الفكر وأهبة العزيمة لكي نواجه مفاجآت ليست دائما متوقعة (وإلا ما كانت مفاجآت) ولكنها قد تحبل بها مرحلة جديدة انهارت فيها الحدود التقليدية بين الداخل والخارج، الوطني والكوني.
ويميط الكتاب اللثام عن مفارقة حادة تتمثل بتهالك عربي مصحوب بانسداد حاد في الآفاق وافتياق شديد إلى القوى والأدوات والبرامج والرؤى والخيارات، مقابل صعود أخرى من محيطنا الجنوبي كانت أوضاعها إلى عقود خلت بأوضاعنا أشبه، وفي أحايين من الوقت، أسوأ. غير أن المفارقة هذه طبيعية تماما بالنسبة إلى المقدمات التي قادت إليها هنا وهناك؛ إذ المجتمعات والدول، مثل الأفراد، لاتحصد سوى مما يتناسب وما زرعته.
ويرى بلقزيز، في الكتاب الذي ألحقه بقراءة عن العملية الروسية الخاصة: روسيا في مواجهة المنظومة الأطلسية، أن أنه لا تستقيم سياسة دولية ولاعلاقات دولية مع وجود اختلال التوازن بين القوى الشريطة في تلك العلاقات، إذ التوازن وحده يضمن صون حقوق الشركاء كافة في النظام الذي هم شركاء فيه.
والنظام الدولي القائم اليوم، والمستمر منذ عام 1945، يتسم بفقدان التوازن. واقترن انهيار التوازن في النظام الدولي بالحدث المفصلي الكبير الذي وقع في الهزيع الاخير من ثمانينيات القرن العشرين؛ بداية انفراط المعسكر الاشتراكي الذي قاده الاتحاد السوفيتي، وتساقط أنظمة الأحزاب الشيوعية فيه تباعا، وصولا إلى سقوط نظام هونيكر في ألمانيا الشرقية ومعه سقوط جدار برلين (نوفمبر 1989)، غير أن اللحظة الحاسمة في ذلك كانت تلك التي تجلت في إنفراط الاتحاد السوفيتي عقب قرار حلّه (ديسمبر 1991)، وهي اللحظة عينها التي يؤرخ بها لنهاية الحرب الباردة بين المعسكريين والعظميين.
ويرى المفكر المغربي أن النظام الدولي اليوم لم يرق نموذجه إلى مستوى النموذج السياسي الحديث، ومازال، حتى إشعار آخر، يمتح قيمه من نظام حالة الطبيعة الهوبزي، مشبّها النظام الدولي الراهن بالنظام الاجتماعي السابق لقيام الدولة على نحو ماتصوره المفكر الإنجليزي توماس هوبز: "نظام حالة الطبيعة"، وهو النظام الخالي من القانون، والقائم على مبدأ القوة وعلىى علاقات التخاوف (الخوف المتبادل)، أي على المبدأ والعلاقة اللذين يؤسسان لما سمّاه "حرب الجميع على الجميع"، وهذا النظام ينقض قانونا طبيعيا، وهو قانون البقاء أو قانون حفقظ النوع الإنساني، الأمر الذي يستحيل معه استتباب الشروط التي تجعل الحياة ممكنة في نظاق أحكام قوانين الطبيعة. وللخروج من تلك الحالة، لا مندوحة، سوى بإقامة المجتمع السياسي (الدولة) والتعاقد بين الناس على بنائه من أجل إقرار الأمن والسلم.
وهكذا نصل إلى بيت القصيد في مسألة النظام الدولي، ومكانة القانون الدولي فيه. إن القويّ عادة، هو من يفرض قانونه، وهل فرض القانون الدولي غير الأقوياء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية؟، هذه واحدة؛ الثانية أن القانون هذا -وإن كان قانون أقوياء- يحفظ بعض مصالح من ليسوا في زمرة الأقوياء، ولذلك هم يوافقون عليه ويعوّلون، ولكن ثالثا، لايملك سلطة تأويل القانون وفرض تأويله، بوصفه التأويل الرسمي الوحيد إلا القويّ. هكذا ينتصر التأويل على النص فلا يبقى للنص من فائدة أو جدوى مع فقدان سلطة تأويله!.
ولا يمكن، وفق بلقزيز، أن تستمر الحال على هذا المنوال مع ظهور التناقض الصارخ- المتزايد تفاقما- بين الهندسة الراهنة للنظام الدولي وقواه من جهة، والمتغيرات الهائلة التي طرأت على العالم- في العقدين الأخيرين- وأنجبت حقائق جديدة: اقتصادية وعلمية وتقانية وعسكرية..، لايلحظها ذلك النظام من جهة أخرى. لذلك، لا مفر للبشرية عن خيار أوحد لحفظ السلم والاستقرار في العالم: إصلاح النظام الدولي ومؤسساته وإعادة بناء قواعده على مبادئ المساواة والشراكة وتوازن المصالح، داعيا إلى منظومة جنوبية جديدة.
ويرى بلقزيز، في كتابه "المتغيرات والصيرورات قراءة في معطيات عالم متحول"، الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، أن التغير قانون حاكم في المجتمع الإنساني، كما في الطبيعة، وما من شيء من ظواهر الاجتماع والاقتصاد والسياسة والمعرفة يظل ثابتا على قوام دائم، حتى وإن بلغ عمرانه من الرسوخ شأوا كبيرا، إذ سرعان ما يأتي على الثابت والراسخ حين من الدهر يتغيّر فيه ويتخذ هيئة جديدة، وإذا كان التغيّر في الطبيعة محكوما بقوانين الطبيعة، فهو في المجتمعات مرتبط بـالإرادة وبالأفعال الإنسانية؛ إذ هي من توجد له الأسباب وتهيئ له الشروط وتفرض إمكاناته على هذا النحو أو ذاك.
ومع ذلك لا تقوى الإرادة الإنسانية، دائما في الأحوال كافة، على أن تتحكم في مجرى التغير الذي تشارك في صنعه، فقد يحصل أن يجدف ضد تيارها، وأن يفرض على صنّاعه حقائق مختلفة ما توقعوها ولا قصدوا إليها حين خاضوا في أمره.
وبرؤية فلسفية فيزيائية، يؤطر بلقزيز فكرة التغيّر بالقول "كلما تواتر التغير في الواقع الإنساني، وتسارع إيقاعه، زادت فرص تنامي مستوى الفعالية الإنسانية أكثر، وذلك لما يتولّد من واقع التغير من معارف وخبرات جديدة تدخل في إعادة تأهيل قدرات الإنسان على الإبداع أكثر، وبالتالي، على صنع ظواهر جديدة في التاريخ. وهكذا ليست الفعالية الإنسانية- بماهي تجسيد للإرادة- وحدها التي تنتج الأسباب التي تزيد من إيقاع التغير وتسرّع وتائره الزمنية، وبالتالي يزداد بسرعته تراكم الظواهر الجديدة -في ميادين العلم والاقتصاد والتكنولوجيا- بل إن هذه الأخيرة سرعان ما تصبح وقودا وطاقة جديدة تشحن بها بطارية تلك الفعالية الإنسانية المنتجة لتعاود فعلها من جديد".
لكنه يقف مستدركا، "غير أن ما تبدعه الفعالية الإنسانية من معطيات مادية وظواهر جديدة، وإن كانت مما تسهل به شروط الحياة وتتسع به الخيارات في المجتمعات ولدى الأفراد، ليس دائما مما يمكن التحكم فيه وفي مساره، ولا مما يقبل استيعاب نتائجه والسيطرة علها في كل الظروف، فرب منتوج ينفصل عن منتجه ويستقل عنه بنظامه الخاص، حتى لقد يصبح في لحظة ما عبئا عليه إن لم يتحول إلى متحكم جديد في ذلك الذي أنتجه وقاد إليه الإنسان، ومن هنا تبدأ المشكلة الكبرى في الإبداع الإنساني: مشكلة الاستلاب، حيث يخرج المصنوع من سلطة الصانع، ويصير الثاني تبعا للأول: يوجهه ويسخّره، ويضرب مثلا على ذلك بالتقنية أو التقانة التي تتحول شيئا فشيئا إلى نظام يصبح الإنسان خاضعا له غير قادر على العيش من دونه، متسائلا: أليس المنتوج هنا، من يتحكم في المنتِج؟، أليس هذا أيضا من مفاعيل قانون التغير؟".
ويرى بلقزيز، أن القاعدة المألوفة في السياسات العليا للدول، أن المستقبلات التي تتغيّاها الأمم والدول لا تأتيها عفوا وبالتلقاء، وإنما تُصنع صنعا ويقع التخطيط لها، بعناية، ويواكب إنجازها القدر الضروري المطلوب من المتابعة والتصحيح والتدارك.
وهكذا يأتي التطور مراقبا ومقترنا بقدر من القصدية ومن تدخل الإرادة الإنسانية في المجرى والمسار، على النحو الذي يتولّد منه الهدف الإنساني المرغوب فيه والمحسوب.
وليس معنى ذلك أن التطور يخضع، حكما، للإرادة الإنسانية ويعدم قوانينه الموضوعية المستقلة، إذ موضوعية عوامله أمر متقرر بقوة أحكام الأشياء والظواهر والقوانين: في الطبيعة كما في العالم الإنساني والتاريخ، غير أن موضوعيته ليست دائما حتمية ولا عمياء، وإنما يتدخل عامل الإرادة الإنسانية في تكييفه وفي توجيه مساره أو في تعديل اتجاهاته أو تصويب حركته.
يقع ذلك أكثر ما يقع حين يكون التطور ذاك محكوما في الغالب بهندسة قبلية (= تخطيط) تأتي حركته تنفيذا لها، أي يكون فيها خاضعا لفعل من العقلنة الاجتماعية: السياسية والاقتصادية، وهو ما ينسحب على التقنية أو التكنولوجيا، على أهميتها، شيأت الإنسان وجردت الفعل الإنساني من كل مضمون إنسانوي، بل حولت الإنسان إلى آلة أو إلى عبد تابع للآلة، ناهيك عن تنميطها فكره وذوقه وقيمه، ناهيك عن إلغائها العمل الإنساني، تدريجيا، والاعتياض عنه بالعمل الآلي، ونواتج ذلك من بطالة وتهميش اجتماعيين وتعطيل لطاقات الإبداع الإنساني.
في كتابه، حاول المؤلف تقديم رواية نقدية عن الأوضاع العربية القائمة والمستمرة تهالكا منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، جنبا إلى جنب مع محاولة مطالعة هذه الحالة من التغير الهائل الذي يشهد عليها العالم من حولنا، رائيا ضرورة مراجعة العقائد السياسية والاقتصادية والثقافة المؤسسة لكل المسار الإنساني الحديث والمعاصر، والتي قادت إلى هذا المنوال الاجتماعي- الاقتصادي وإلى هذا النظام السياسي السائدين في العالم، وما استجرّاه من مشكلات وأزمات وحروب وتفاوتات صارخة بين البشر، مؤكدا أن هذا النظام وهذا النموذج (المنوال) شربا كأسهما المُرّة الأخيرة؛ بمناسبة جائحة كورونا التي سقطا أمامها سقوطا مدويا.
فتجربة ما سمي بـ"الربيع العربي"، في مطلع العقد الثاني من هذا القرن، وانتفاضتي شعبي السودان والجزائر، في خواتيم العقد نفسه، تطلعنا على الكم الهائل من المشكلات والأزمات التي تعتمل في الداخل الاجتماعي والسياسي للبلاد العربية، وهي التي كانت في أساس الانفجارات تلك؛ مشكلات الاستبداد السياسي، والتسلطية وخنق الحريات العامة، الفساد المالي والسياسي والإداري، الفقر والتهميش الاجتماعي، الناجمين من الافتقار الكامل إلى أي مظهر من مظاهر العدالة الاجتماعية ومن سوء توزيع الثروة، والفشل التنموي الذريع ونتائجه الاجتماعية الحادة (= تزايد الفوارق الفاحشة بين الطبقات الاجتماعية)؛ التحيُّف الفاضح في حقوق النساء والشباب، هشاشة بنى المواطنية وروابطها ممثلة في انبعاث النعرات العصبوية والأقوامية الإنقسامية.. الخ، ولقد اجتمعت هذه المشكلات، كلا أو بعضا، لتهيئ الأسباب العميقة للانفجارات الشعبية تلك، حتى بمعزل عن أي عوامل أخرى استجدت عليها، وكان لها بالغ الأثر في ما حصل خلال ما يزيد على عقد من ذلك "الربيع".
ويحذر بلقزيز، أنه ما من شيء يدعونا إلى الاطمئنان إلى وضع ملتبس كالذي نحن فيه اليوم، إلى الركون، مثلا، أو الاعتقاد أن استقرارنا قد يتأمّن عبر السير في ما نحن فيه نسير، وما اعتدنا، طويلا من عوائد من قبيل تجاهل المشكلات العميقة في اجتماعنا السياسي، أو إهمال أو لوياتها والميل إلى ترحيلها أو تأجيلها إلى أزمان مقبلة، أو إلى الركون إلى الاعتقاد في سلامة تشخيصنا للتحديات الداخلية والخارجية التي تمتحن أمن مجتمعاتنا ودولنا واستقرارها، أو من قبيل استسهال شأن بعض المطالبات التي قد تبدو لنا غير ذات قدرة على ممارسة التهديد، لمجرد أن حَمَلَتها أقلية وغير ذي بأس وشدة، متناسين أنها مطالبات لاتقوى وتعظم بقوة حَمَلَتها الداخليين، وإنما تستفحل حين يلتقطها من يلتقط من حوامل خارجية. وبكلمة لابديل لنا من يقظة الفكر وأهبة العزيمة لكي نواجه مفاجآت ليست دائما متوقعة (وإلا ما كانت مفاجآت) ولكنها قد تحبل بها مرحلة جديدة انهارت فيها الحدود التقليدية بين الداخل والخارج، الوطني والكوني.
ويميط الكتاب اللثام عن مفارقة حادة تتمثل بتهالك عربي مصحوب بانسداد حاد في الآفاق وافتياق شديد إلى القوى والأدوات والبرامج والرؤى والخيارات، مقابل صعود أخرى من محيطنا الجنوبي كانت أوضاعها إلى عقود خلت بأوضاعنا أشبه، وفي أحايين من الوقت، أسوأ. غير أن المفارقة هذه طبيعية تماما بالنسبة إلى المقدمات التي قادت إليها هنا وهناك؛ إذ المجتمعات والدول، مثل الأفراد، لاتحصد سوى مما يتناسب وما زرعته.
ويرى بلقزيز، في الكتاب الذي ألحقه بقراءة عن العملية الروسية الخاصة: روسيا في مواجهة المنظومة الأطلسية، أن أنه لا تستقيم سياسة دولية ولاعلاقات دولية مع وجود اختلال التوازن بين القوى الشريطة في تلك العلاقات، إذ التوازن وحده يضمن صون حقوق الشركاء كافة في النظام الذي هم شركاء فيه.
والنظام الدولي القائم اليوم، والمستمر منذ عام 1945، يتسم بفقدان التوازن. واقترن انهيار التوازن في النظام الدولي بالحدث المفصلي الكبير الذي وقع في الهزيع الاخير من ثمانينيات القرن العشرين؛ بداية انفراط المعسكر الاشتراكي الذي قاده الاتحاد السوفيتي، وتساقط أنظمة الأحزاب الشيوعية فيه تباعا، وصولا إلى سقوط نظام هونيكر في ألمانيا الشرقية ومعه سقوط جدار برلين (نوفمبر 1989)، غير أن اللحظة الحاسمة في ذلك كانت تلك التي تجلت في إنفراط الاتحاد السوفيتي عقب قرار حلّه (ديسمبر 1991)، وهي اللحظة عينها التي يؤرخ بها لنهاية الحرب الباردة بين المعسكريين والعظميين.
ويرى المفكر المغربي أن النظام الدولي اليوم لم يرق نموذجه إلى مستوى النموذج السياسي الحديث، ومازال، حتى إشعار آخر، يمتح قيمه من نظام حالة الطبيعة الهوبزي، مشبّها النظام الدولي الراهن بالنظام الاجتماعي السابق لقيام الدولة على نحو ماتصوره المفكر الإنجليزي توماس هوبز: "نظام حالة الطبيعة"، وهو النظام الخالي من القانون، والقائم على مبدأ القوة وعلىى علاقات التخاوف (الخوف المتبادل)، أي على المبدأ والعلاقة اللذين يؤسسان لما سمّاه "حرب الجميع على الجميع"، وهذا النظام ينقض قانونا طبيعيا، وهو قانون البقاء أو قانون حفقظ النوع الإنساني، الأمر الذي يستحيل معه استتباب الشروط التي تجعل الحياة ممكنة في نظاق أحكام قوانين الطبيعة. وللخروج من تلك الحالة، لا مندوحة، سوى بإقامة المجتمع السياسي (الدولة) والتعاقد بين الناس على بنائه من أجل إقرار الأمن والسلم.
وهكذا نصل إلى بيت القصيد في مسألة النظام الدولي، ومكانة القانون الدولي فيه. إن القويّ عادة، هو من يفرض قانونه، وهل فرض القانون الدولي غير الأقوياء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية؟، هذه واحدة؛ الثانية أن القانون هذا -وإن كان قانون أقوياء- يحفظ بعض مصالح من ليسوا في زمرة الأقوياء، ولذلك هم يوافقون عليه ويعوّلون، ولكن ثالثا، لايملك سلطة تأويل القانون وفرض تأويله، بوصفه التأويل الرسمي الوحيد إلا القويّ. هكذا ينتصر التأويل على النص فلا يبقى للنص من فائدة أو جدوى مع فقدان سلطة تأويله!.
ولا يمكن، وفق بلقزيز، أن تستمر الحال على هذا المنوال مع ظهور التناقض الصارخ- المتزايد تفاقما- بين الهندسة الراهنة للنظام الدولي وقواه من جهة، والمتغيرات الهائلة التي طرأت على العالم- في العقدين الأخيرين- وأنجبت حقائق جديدة: اقتصادية وعلمية وتقانية وعسكرية..، لايلحظها ذلك النظام من جهة أخرى. لذلك، لا مفر للبشرية عن خيار أوحد لحفظ السلم والاستقرار في العالم: إصلاح النظام الدولي ومؤسساته وإعادة بناء قواعده على مبادئ المساواة والشراكة وتوازن المصالح، داعيا إلى منظومة جنوبية جديدة.











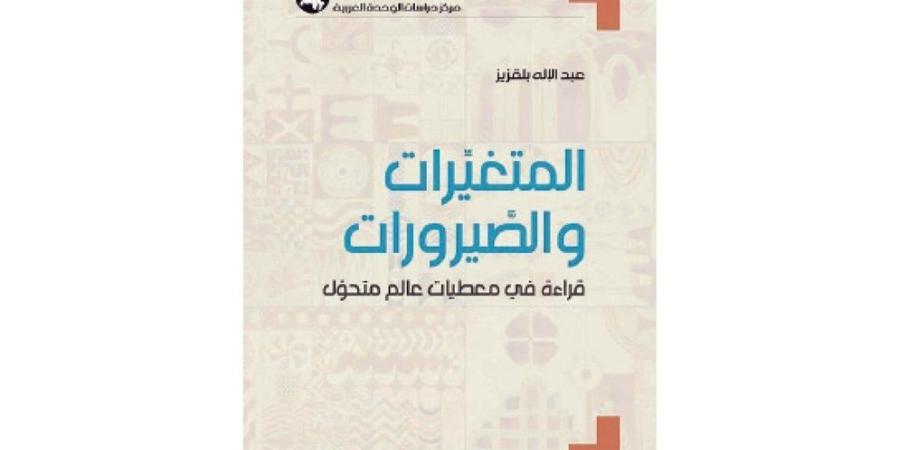







0 تعليق