loading ad...
تُعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد تأسست بموجب المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة لتحل محل المحكمة الدائمة للعدل الدولية. يقع مقرها في لاهاي بهولندا، وتضطلع بدورين رئيسيين: الفصل في النزاعات القانونية بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية المعروضة عليها من قبل الهيئات الدولية المخولة بذلك.اضافة اعلان
الرأي الاستشاري هو بيان قانوني غير ملزم تصدره المحكمة بناءً على طلب من جهة مخولة، كالجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو بعض الوكالات المتخصصة. ويُستند في ذلك إلى المادة 96 من الميثاق التي تنص على:
"يجوز للجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي الاستشاري في أي مسألة قانونية."
وفي هذه القضية، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022 رأيًا استشاريًا من المحكمة بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مستندة إلى اختصاصها في معالجة المسائل القانونية ذات الطابع الدولي.
تمثل هذه الطلبات وسيلة سلمية لتعزيز احترام القانون الدولي، وتوفير مرجعية قانونية للأطراف المعنية والمجتمع الدولي، رغم أن الآراء الاستشارية لا تملك قوة الإلزام، لكنها ذات ثقل معنوي وقانوني كبير، وغالبًا ما تمهد لاتخاذ قرارات لاحقة على المستوى الدولي.
في مرافعة اتسمت بالوضوح القانوني والدبلوماسي الرفيع، استعرض الوفد الأردني أمام محكمة العدل الدولية جملة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مستندًا إلى مبادئ القانون الدولي العام، والاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتأكيد عدم شرعية الاحتلال وتبعاته القانونية.
في صلب مرافعة الأردن، برز التأكيد على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق مكفول بموجب المادة الأولى من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لعام 1966، وقرار الجمعية العامة رقم 1514 لسنة 1960 بشأن تصفية الاستعمار.
وقد أشار الأردن إلى أن حرمان الفلسطينيين من هذا الحق يشكل خرقًا جوهريًا لأسس النظام القانوني الدولي، ولا سيما في ظل السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس واقع ضم فعلي للأراضي المحتلة.
كما شددت المرافعة الأردنية على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لا سيما المادة 49 التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
وقد استشهد الأردن بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، الذي أكد أن المستوطنات لا تمتلك أي شرعية قانونية وتشكل خرقًا فادحًا للقانون الدولي، مطالبًا المحكمة بتأكيد هذا التوصيف القانوني في رأيها الاستشاري.
ومن جهة أخرى وفي أحد أهم محاور المرافعة، دفع الوفد الأردني بأن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز طبيعته المؤقتة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وأصبح يسعى إلى الإدامة والضم الفعلي، بما يناقض المبادئ الأساسية الواردة في اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة، التي ترى في الاحتلال وضعًا مؤقتًا لا يمنح الدولة المحتلة حق السيادة.
وفي نفس السياق لم تغفل المرافعة الإشارة إلى نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي تفرضه إسرائيل من خلال جدران الفصل، والقيود على الحركة، والقوانين التمييزية. وقد أدرج الأردن هذه الممارسات ضمن انتهاكات الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، مطالبًا المحكمة بالنظر إليها كأدلة على وجود سياسة تمييز ممنهجة تتعارض مع القواعد القطعية في القانون الدولي (Jus Cogens).
بهذا العرض، قدّم الأردن مرافعة تستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة، في محاولة لإعادة صياغة الموقف القانوني الدولي تجاه الاحتلال الإسرائيلي، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
لم تكن المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل الدولية مجرد استعراض لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض والإنسان، بل تجاوزت ذلك لتسلط الضوء على مخاطر الاستهداف الإسرائيلي للمؤسسات الدولية وموظفيها، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقد جاء هذا التركيز انطلاقًا من التزامات المجتمع الدولي في احترام الحصانة الوظيفية للأطراف الفاعلة ضمن منظومة الأمم المتحدة، باعتبارها ركيزة لضمان الحياد والاستقلال في أداء المهام الإنسانية.
في هذا الإطار، شدد الأردن على أن المساس بموظفي الأمم المتحدة أو المؤسسات التابعة لها يشكل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تمنح موظفي المنظمة، بما فيهم موظفو الأونروا، حصانة وظيفية تامة من الإجراءات القضائية أو الإدارية الوطنية، في ما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية. هذه الاتفاقية تُعد أحد الأعمدة القانونية التي تضمن سير عمل المنظمات الدولية دون تدخل أو ترهيب من الدول المضيفة أو سلطات الاحتلال.
وإضافة إلى ما سبق، أشار الوفد الأردني إلى أن محاولات إسرائيل إلغاء عمل الأونروا من القدس الشرقية وباقي الأراضي المحتلة تشكل خرقًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما القرار رقم 302 لعام 1949 الذي أنشأ الوكالة وكلفها بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم. وبالتالي، فإن أي مساس بوجود الوكالة أو تعطيل لبرامجها يُعد تعديًا على الإرادة الدولية وعلى حقوق اللاجئين أنفسهم.
علاوة على ذلك، ترتبط حماية الموظفين الدوليين بمسؤولية قانونية تترتب على الدولة المضيفة أو المحتلة. فبموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 27 وما بعدها)، تلتزم قوة الاحتلال بحماية جميع الأشخاص المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وعدم تعريضهم لأذى أو مضايقات.
ويمكن القول إن الأردن، من خلال هذه المرافعة، قد نقل القضية من بعدها السياسي والإنساني إلى فضاء قانوني دولي واضح المعالم، مطالبًا المحكمة بإعادة التأكيد على أن احترام القانون الدولي لا يقتصر على وقف الاستيطان أو إنهاء الاحتلال فقط، بل يشمل أيضًا احترام آليات العمل الأممي، ورفض أي استهداف للمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وهكذا، فإن هذه المرافعة فتحت الباب أمام المحكمة لأن تتناول في رأيها الاستشاري ليس فقط مدى مشروعية الاحتلال، بل أيضًا مسؤولية إسرائيل القانونية عن تعقيد عمل الهيئات الدولية وتقييد أنشطتها، وهو ما يرقى إلى عرقلة متعمدة للعمل الإنساني الدولي وخرق لمبادئ الأمم المتحدة ذاتها.
لم تخلُ المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل الدولية من البعد الإنساني كذلك ، بل جعلته في قلب خطابها القانوني، في ظل الكارثة المتفاقمة التي يعيشها قطاع غزة جراء الحرب والعدوان والحصار المستمر. فقد انطلقت المرافعة من المبادئ الإنسانية الأساسية في القانون الدولي، لتطالب بوضوح بضرورة وقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود.
وأبرز الوفد الأردني ما يعانيه سكان غزة من حرمان من الغذاء والدواء والماء، مشيرًا إلى أن هذا الحصار والعنف العسكري يرقى إلى العقاب الجماعي، بما يخالف بشكل مباشر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولا سيما المادتين 55 و56، اللتين تُلزمان الدولة المحتلة بضمان توفير المواد الغذائية والرعاية الطبية للسكان المدنيين الواقعين تحت سلطتها. كما شدد على أن الاستهداف العشوائي أو الممنهج للمدنيين والبنى التحتية المدنية يُعد خرقًا صارخًا لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني.
وفي ذات السياق، استند الأردن إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/21 الصادر في أكتوبر 2023، والذي طالب بوقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية فورًا إلى قطاع غزة. واعتبر أن استمرار تجاهل هذا القرار من قبل سلطات الاحتلال يُشكل تحديًا خطيرًا للإرادة الدولية، ويمثل تقويضًا لمكانة الأمم المتحدة وقراراتها.
كما نوّه الوفد الأردني بأن المملكة، انطلاقًا من دورها التاريخي والإنساني، تواصل إرسال قوافل الإغاثة البرية والجوّية إلى قطاع غزة، رغم القيود الشديدة المفروضة، مشيرًا إلى أن تعطيل هذه المساعدات يُعد مخالفة للقانون الدولي، ويعرض حياة الآلاف للخطر. وفي ذلك، استند الأردن إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العمليات الإنسانية، والتي تكرّس مبدأ "الوصول الإنساني غير المقيّد".
وقد وجّهت المرافعة نداءً واضحًا إلى المحكمة بأن تأخذ بعين الاعتبار في رأيها الاستشاري هذه الأبعاد الأخلاقية والإنسانية، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي لا ينتهك فقط القانون، بل يُمعن في إنتاج معاناة إنسانية واسعة النطاق، تتطلب موقفًا قانونيًا صارمًا يُلزم المجتمع الدولي بوقف الجرائم وتفعيل آليات المساءلة.
من خلال هذا الطرح، دمج الأردن في مداخلته القضائية الوجدان الإنساني بالمنطق القانوني، مؤكدًا أن احترام القانون الدولي لا يقاس فقط بالنصوص، بل بمدى تأثيرها في صون الحياة الإنسانية وضمان الكرامة للسكان المدنيين في أوقات النزاعات.
جاءت المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لتشكل إضافة نوعية إلى مسار بناء سجل قانوني دولي رصين يُدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ليس فقط من زاوية الموقف السياسي أو الأخلاقي، بل عبر أدوات القانون الدولي ذات الحجية الملزمة، التي تعتمدها أعلى هيئة قضائية دولية في العالم.
لقد تمكن الأردن، من خلال لغته القانونية المحكمة ومضامينه الحاسمة، من أن يُسهم بفعالية في صياغة خطاب دولي يقوم على مبدأ عدم مشروعية الاحتلال، وتجريم الاستيطان، وتجريم العقاب الجماعي، والدفاع عن الحق في تقرير المصير. وفي ذلك، لم تكن المرافعة خطابًا إنشائيًا، بل كانت وثيقة قانونية متماسكة يُمكن أن تُستخدم لاحقًا كمرجع في المحافل الدولية ومداولات الأمم المتحدة.
وإذ يحمل هذا التحرك بُعدًا رمزيًا كبيرًا في مواجهة محاولات تطبيع الاحتلال وتطويع القانون الدولي، فإن الرسالة التي وجهها الأردن للمجتمع الدولي كانت واضحة: لقد آن الأوان لتحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال الأطول في العصر الحديث. فاستمرار الصمت، أو الاكتفاء بالتنديد، يُعد تواطؤًا ضمنيًا مع واقع غير مشروع، لا يمكن قبوله في نظام دولي يفترض أنه قائم على سيادة القانون والمساواة بين الدول والشعوب.
وختامًا، فإن القانون الدولي، وإن طال الزمن، يظل أداة فعالة للمحاسبة ونصرة الشعوب المحتلة. وما مرافعة الأردن إلا شاهدا على أن صوت الحق، حين يصدر من منبر قانوني نزيه، قادر على أن يُعيد التوازن لمعادلات مختلة، ويُمهّد الطريق نحو عدالة طال انتظارها، ويُبقي جذوة الأمل مشتعلة في نفوس الشعوب التي تنشد الحرية والكرامة.
الرأي الاستشاري هو بيان قانوني غير ملزم تصدره المحكمة بناءً على طلب من جهة مخولة، كالجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو بعض الوكالات المتخصصة. ويُستند في ذلك إلى المادة 96 من الميثاق التي تنص على:
"يجوز للجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي الاستشاري في أي مسألة قانونية."
وفي هذه القضية، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022 رأيًا استشاريًا من المحكمة بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مستندة إلى اختصاصها في معالجة المسائل القانونية ذات الطابع الدولي.
تمثل هذه الطلبات وسيلة سلمية لتعزيز احترام القانون الدولي، وتوفير مرجعية قانونية للأطراف المعنية والمجتمع الدولي، رغم أن الآراء الاستشارية لا تملك قوة الإلزام، لكنها ذات ثقل معنوي وقانوني كبير، وغالبًا ما تمهد لاتخاذ قرارات لاحقة على المستوى الدولي.
في مرافعة اتسمت بالوضوح القانوني والدبلوماسي الرفيع، استعرض الوفد الأردني أمام محكمة العدل الدولية جملة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مستندًا إلى مبادئ القانون الدولي العام، والاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتأكيد عدم شرعية الاحتلال وتبعاته القانونية.
في صلب مرافعة الأردن، برز التأكيد على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق مكفول بموجب المادة الأولى من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لعام 1966، وقرار الجمعية العامة رقم 1514 لسنة 1960 بشأن تصفية الاستعمار.
وقد أشار الأردن إلى أن حرمان الفلسطينيين من هذا الحق يشكل خرقًا جوهريًا لأسس النظام القانوني الدولي، ولا سيما في ظل السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس واقع ضم فعلي للأراضي المحتلة.
كما شددت المرافعة الأردنية على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لا سيما المادة 49 التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
وقد استشهد الأردن بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، الذي أكد أن المستوطنات لا تمتلك أي شرعية قانونية وتشكل خرقًا فادحًا للقانون الدولي، مطالبًا المحكمة بتأكيد هذا التوصيف القانوني في رأيها الاستشاري.
ومن جهة أخرى وفي أحد أهم محاور المرافعة، دفع الوفد الأردني بأن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز طبيعته المؤقتة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وأصبح يسعى إلى الإدامة والضم الفعلي، بما يناقض المبادئ الأساسية الواردة في اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة، التي ترى في الاحتلال وضعًا مؤقتًا لا يمنح الدولة المحتلة حق السيادة.
وفي نفس السياق لم تغفل المرافعة الإشارة إلى نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي تفرضه إسرائيل من خلال جدران الفصل، والقيود على الحركة، والقوانين التمييزية. وقد أدرج الأردن هذه الممارسات ضمن انتهاكات الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، مطالبًا المحكمة بالنظر إليها كأدلة على وجود سياسة تمييز ممنهجة تتعارض مع القواعد القطعية في القانون الدولي (Jus Cogens).
بهذا العرض، قدّم الأردن مرافعة تستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة، في محاولة لإعادة صياغة الموقف القانوني الدولي تجاه الاحتلال الإسرائيلي، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
لم تكن المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل الدولية مجرد استعراض لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض والإنسان، بل تجاوزت ذلك لتسلط الضوء على مخاطر الاستهداف الإسرائيلي للمؤسسات الدولية وموظفيها، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقد جاء هذا التركيز انطلاقًا من التزامات المجتمع الدولي في احترام الحصانة الوظيفية للأطراف الفاعلة ضمن منظومة الأمم المتحدة، باعتبارها ركيزة لضمان الحياد والاستقلال في أداء المهام الإنسانية.
في هذا الإطار، شدد الأردن على أن المساس بموظفي الأمم المتحدة أو المؤسسات التابعة لها يشكل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تمنح موظفي المنظمة، بما فيهم موظفو الأونروا، حصانة وظيفية تامة من الإجراءات القضائية أو الإدارية الوطنية، في ما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية. هذه الاتفاقية تُعد أحد الأعمدة القانونية التي تضمن سير عمل المنظمات الدولية دون تدخل أو ترهيب من الدول المضيفة أو سلطات الاحتلال.
وإضافة إلى ما سبق، أشار الوفد الأردني إلى أن محاولات إسرائيل إلغاء عمل الأونروا من القدس الشرقية وباقي الأراضي المحتلة تشكل خرقًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما القرار رقم 302 لعام 1949 الذي أنشأ الوكالة وكلفها بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم. وبالتالي، فإن أي مساس بوجود الوكالة أو تعطيل لبرامجها يُعد تعديًا على الإرادة الدولية وعلى حقوق اللاجئين أنفسهم.
علاوة على ذلك، ترتبط حماية الموظفين الدوليين بمسؤولية قانونية تترتب على الدولة المضيفة أو المحتلة. فبموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 27 وما بعدها)، تلتزم قوة الاحتلال بحماية جميع الأشخاص المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وعدم تعريضهم لأذى أو مضايقات.
ويمكن القول إن الأردن، من خلال هذه المرافعة، قد نقل القضية من بعدها السياسي والإنساني إلى فضاء قانوني دولي واضح المعالم، مطالبًا المحكمة بإعادة التأكيد على أن احترام القانون الدولي لا يقتصر على وقف الاستيطان أو إنهاء الاحتلال فقط، بل يشمل أيضًا احترام آليات العمل الأممي، ورفض أي استهداف للمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وهكذا، فإن هذه المرافعة فتحت الباب أمام المحكمة لأن تتناول في رأيها الاستشاري ليس فقط مدى مشروعية الاحتلال، بل أيضًا مسؤولية إسرائيل القانونية عن تعقيد عمل الهيئات الدولية وتقييد أنشطتها، وهو ما يرقى إلى عرقلة متعمدة للعمل الإنساني الدولي وخرق لمبادئ الأمم المتحدة ذاتها.
لم تخلُ المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل الدولية من البعد الإنساني كذلك ، بل جعلته في قلب خطابها القانوني، في ظل الكارثة المتفاقمة التي يعيشها قطاع غزة جراء الحرب والعدوان والحصار المستمر. فقد انطلقت المرافعة من المبادئ الإنسانية الأساسية في القانون الدولي، لتطالب بوضوح بضرورة وقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود.
وأبرز الوفد الأردني ما يعانيه سكان غزة من حرمان من الغذاء والدواء والماء، مشيرًا إلى أن هذا الحصار والعنف العسكري يرقى إلى العقاب الجماعي، بما يخالف بشكل مباشر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولا سيما المادتين 55 و56، اللتين تُلزمان الدولة المحتلة بضمان توفير المواد الغذائية والرعاية الطبية للسكان المدنيين الواقعين تحت سلطتها. كما شدد على أن الاستهداف العشوائي أو الممنهج للمدنيين والبنى التحتية المدنية يُعد خرقًا صارخًا لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني.
وفي ذات السياق، استند الأردن إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/21 الصادر في أكتوبر 2023، والذي طالب بوقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية فورًا إلى قطاع غزة. واعتبر أن استمرار تجاهل هذا القرار من قبل سلطات الاحتلال يُشكل تحديًا خطيرًا للإرادة الدولية، ويمثل تقويضًا لمكانة الأمم المتحدة وقراراتها.
كما نوّه الوفد الأردني بأن المملكة، انطلاقًا من دورها التاريخي والإنساني، تواصل إرسال قوافل الإغاثة البرية والجوّية إلى قطاع غزة، رغم القيود الشديدة المفروضة، مشيرًا إلى أن تعطيل هذه المساعدات يُعد مخالفة للقانون الدولي، ويعرض حياة الآلاف للخطر. وفي ذلك، استند الأردن إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العمليات الإنسانية، والتي تكرّس مبدأ "الوصول الإنساني غير المقيّد".
وقد وجّهت المرافعة نداءً واضحًا إلى المحكمة بأن تأخذ بعين الاعتبار في رأيها الاستشاري هذه الأبعاد الأخلاقية والإنسانية، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي لا ينتهك فقط القانون، بل يُمعن في إنتاج معاناة إنسانية واسعة النطاق، تتطلب موقفًا قانونيًا صارمًا يُلزم المجتمع الدولي بوقف الجرائم وتفعيل آليات المساءلة.
من خلال هذا الطرح، دمج الأردن في مداخلته القضائية الوجدان الإنساني بالمنطق القانوني، مؤكدًا أن احترام القانون الدولي لا يقاس فقط بالنصوص، بل بمدى تأثيرها في صون الحياة الإنسانية وضمان الكرامة للسكان المدنيين في أوقات النزاعات.
جاءت المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لتشكل إضافة نوعية إلى مسار بناء سجل قانوني دولي رصين يُدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ليس فقط من زاوية الموقف السياسي أو الأخلاقي، بل عبر أدوات القانون الدولي ذات الحجية الملزمة، التي تعتمدها أعلى هيئة قضائية دولية في العالم.
لقد تمكن الأردن، من خلال لغته القانونية المحكمة ومضامينه الحاسمة، من أن يُسهم بفعالية في صياغة خطاب دولي يقوم على مبدأ عدم مشروعية الاحتلال، وتجريم الاستيطان، وتجريم العقاب الجماعي، والدفاع عن الحق في تقرير المصير. وفي ذلك، لم تكن المرافعة خطابًا إنشائيًا، بل كانت وثيقة قانونية متماسكة يُمكن أن تُستخدم لاحقًا كمرجع في المحافل الدولية ومداولات الأمم المتحدة.
وإذ يحمل هذا التحرك بُعدًا رمزيًا كبيرًا في مواجهة محاولات تطبيع الاحتلال وتطويع القانون الدولي، فإن الرسالة التي وجهها الأردن للمجتمع الدولي كانت واضحة: لقد آن الأوان لتحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال الأطول في العصر الحديث. فاستمرار الصمت، أو الاكتفاء بالتنديد، يُعد تواطؤًا ضمنيًا مع واقع غير مشروع، لا يمكن قبوله في نظام دولي يفترض أنه قائم على سيادة القانون والمساواة بين الدول والشعوب.
وختامًا، فإن القانون الدولي، وإن طال الزمن، يظل أداة فعالة للمحاسبة ونصرة الشعوب المحتلة. وما مرافعة الأردن إلا شاهدا على أن صوت الحق، حين يصدر من منبر قانوني نزيه، قادر على أن يُعيد التوازن لمعادلات مختلة، ويُمهّد الطريق نحو عدالة طال انتظارها، ويُبقي جذوة الأمل مشتعلة في نفوس الشعوب التي تنشد الحرية والكرامة.















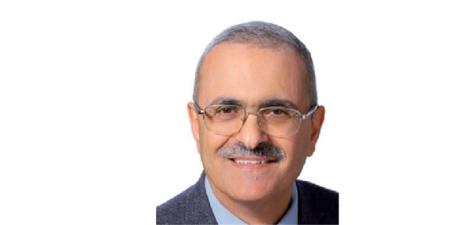

0 تعليق