loading ad...
عمان – نظم مركز "تعلم وأعلم" للأبحاث والدراسات ندوة بعنوان "شعرية ونقدية"، تناولت محطات بارزة في التجربة الشعرية للشاعر علي البتيري، من خلال قراءات قدمها الشاعر بنفسه، إلى جانب ورقة نقدية سلطت الضوء على أبعاد الإبداع في قصائده، التي تعكس عمقا فلسفيا وتفردا لغويا لافتا.اضافة اعلان
شارك في الندوة، إلى جانب الشاعر، الناقد الدكتور إبراهيم خليل، الذي قدم ورقة نقدية تناولت ديوان "نهر لشجر العاشق"، الصادر بدعم من وزارة الثقافة عن دار الخليج للنشر والتوزيع، وأدارها الدكتور أحمد ماضي أول من أمس، في مقر رابطة الكتاب الأردنيين.
يعد علي البتيري من الأسماء البارزة في الساحة الشعرية العربية، وصاحب تجربة شعرية متميزة، تنبض كلماته بأحلام الوطن، وأوجاعه، وآماله في غد أفضل. واستهل الشاعر البتيري الندوة بقراءة مجموعة من قصائده التي تناولت مدينة القدس والمسجد الأقصى، ومنها: "قلبي على القدس"، "إنها القدس"، "طفل غزي يسأل"، "حنين إلى الأقصى"، "من مذكرة عربي نسي أن يموت"، "نداء الجيل". وفي مقطع قصيدة "قلبي على القدس"، قرأ الشاعر: "قلبي على القدس ما مرَّ الزمان عل قلبي/ولم يرهُ إلا على القدسِ/حبيبتي القدسُ فوق العشق أعشقها/أغلى على النفس في دنيايَ/ من نفسي/أم المدائن نور الله باركها/وكل صبحٍ حكى يا ليتها شمسي/ في العقل ماثلة في الروح والحسن/ الانبياء استر احوا في مداخله/ والفاتحون انبروا بالسيف والتر/يجاهدون وعين الحق شاهدة/على مدى الفرق بين اليوم والام/فاليوم لا صحوة كبرى فتوقظنا".
ومن قصيدة حنين إلى الأقصى" يقول الشاعر في مقطع منها: "أيطيبُ غيشٌ ءأو يروق منامُ/والمسجد الأقصى الأسير يُضامُ؟/ تعوي ذئابُ، الليل في باحاته/ويفيض ظلمٌ حوله وظلامُ/مسرى النبي مطوّقٌ بحواجزٍ/وصلاتُنا بين الحراب تقامُ".
ومن قصيدة نداء الجيل: "الأرضُ أرضي مذ عرفتُ ربوعها/فالقدس روحي والخليل فؤادي/والضفة الخضراء روضة ناظري/وأريج يافا مُنيتي ومرادي/والسلطُ درة موطني في حسنها/ورباك يا عجلون تاجُ وِهادي/أردنُّ أنتَ الماءُ في ظمأ الهوى/وشذى فلسطينَ الحبيبةِ زادي".
ثم قدم الدكتور إبراهيم خليل ورقة نقدية حول ديوان "نهر لشجر العاشق"، للشاعر علي البتيري قال فيها إن الشاعر يكتب الشعر منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، وأصدر عددا غير قليل من الدواوين، ونشر عددا كبيرا من القصائد في الصحف والدوريات، وساهم في العديد من الملتقيات الشعرية، والأماسي، والندوات، سواء على المستوى العربي أو المحلي.
وقد حاز الشاعر غير قليل من الجوائز في مجالات الشعر، وشعر الأطفال، والأغنيات الإذاعية، وهو أمر لا ينكر فضله، ولا يجحد أصله وفصله.
ورأى خليل أن صورة الأب الذي يعشق الزيتون تتسع وتترسخ، لتستوعب الكثير من الآباء الفلاحين الذين يعشقون التراب، والكروم، والسهول، والسفوح، فضلا عن الجبال، والمدى المُزنر بسلاسل من القمم الشوامخ. فهذا الفلاح أب لا يمل الحديث عن عشقه لتلك الشجرة: شجرة الزيتون، وحنوه عليها مثلما يحنو الطير على فراخه في العش. ولا يفتأ يغني للدالية، محترسا حذرا من عيون الأعداء: "وأبي ظل، يرحمه الله،/محترسا من عيون الرياح/تداعت عليه بأكفانها/فلاذ بزيتونة ظللت روحه/واستراح".
وبين خليل أنه في قصيدة "قنديل في الذاكرة" (ص 62)، فنجد البساطة نفسها، واللغة الشعرية ذاتها، التي تنأى عن الخطابة والمباشرة، لتقدم المعنى في صورة لا تحتاج من المتلقي إلا إلى قليل من التأويل. فالجد يخشى أن يموت في منفاه، دون أن يتاح له أن يلقي نظرة الوداع على الوطن الذي أحب: "لا أحب الموت أن يأتي بنومي/مثل لص يرتدي ثوب الظلام/يقبض الروح ويمضي/تاركا جثمان عشقي في المنام/دون أن ألقي بروحي/لحظة الموت على وجه فلسطين السلام".
وأضاف خليل أن هذا النموذج يضاف إلى صورة الأب المتمسك بالزيتون حتى اللحظة الأخيرة. فهو لا يبالي بالموت، ولا يخشاه، ولا يتشبث بالحياة، بل إن الشيء الوحيد الذي يرهبه هو أن يفارق هذا العالم من دون أن يلقي النظرة الأخيرة على وطنه، فلسطين.
ولا يفتأ الشاعر يكرر هذه الصورة للأب الراحل، الذي ترك في نفس الابن الكوابيس عوضا عن الأحلام، إذ غدا بعده يعاني – فوق فراق الوطن – اليتم القلبي. فهو لا يلتقي الأحباب، ولم يعد قادرا على كتابة الشعر، فكأن الإلهام قد جفاه، والوحي يتحاشاه: "مذ مات أبي/صارت أحلامي/بلقاء الأحباب بعيدة/مذ مات أبي/وتيتَّم قلبي/لم أكتب في عينيك قصيدة".
وفي صورة أخرى، تمتد قصيدة السيرة لدى الشاعر في مشاهد تتآلف ولا تختلف، فنجد صورة الأم التي تخشى على ابنها من البرد القارس، فتعلق فوق رأسه معطفا من تراب أبيه الراحل، ويخاطبه طيفها قائلا إنها لم تدع وسيلة من وسائل الوقاية إلا استخدمتها، ولا نوعا من الملابس إلا وألبسته إياه. ولهذا يقول طيف الأم: "تدفّأ،/ترابُ أبيك لروحك ثوبٌ/عليكَ أحنّ،/ولو كنتَ مرتديًا كلّ ما في بلادِ الأسى/من ثياب".
وأشار خليل إلى أن الأم، التي ترمز – في رأينا – إلى الصامدين على تراب الوطن، الذين لم يهجروه، تتساءل عن المغتربين في المنافي: متى يعودون إلى شواطئ العمر التي غادروها منذ زمن؟ فهي، بلا ريب، تتوق مثلهم إلى تلك العودة المعطرة بأريج اللقاء، وعطر المحبّة، والشوق اليقظ الذي لم ينم: "ويمِّم جراحك شطر البحار التي/تستحمّ نجومُ المحبّين فيها/بعطر اللقاء المُذاب".
كما أن الأم بحسب خليل، قد شاخ الشوق في قلبها وهي تنتظر عودة الغائب، بلا جدوى. حتى الأخبار التي كانت تصلها منه أو عنه، أصبحت نادرة، وغابت عنها رسائله، وانقطعت، رغم ما تعانيه، ويعانيه هو الآخر من شوق وحنين: "وأنا ما زلتُ في/شوقٍ لأمّي/وعلى قِمّة أحزاني/أُغنّي".
فمن شدة ما يشعر به المتكلم من شوق، لم يعد يفرق بين اللذة والألم؛ فالغناء هنا ليس تعبيرا عن السعادة، بل بوح بالأوجاع، وصوت قلب مثقَل بالحزن. وهذه المفارقة تعبر عن جوهر التجربة الشعرية لدى الشاعر، وتشبه تلك المفارقة التي تختم بعض قصائده القصيرة.
ففي إحدى قصائد ديوانه "لماذا رميت ورود دمي"، يكتب: "كيف لي أن أصدّق شيخَ الكلام/بعد أن قال لي/وهو يلفظ أنفاسه ويموت:/عاش... عاش... السكوت!".
ويتحدث خليل عن القصيدة القصيرة قائلا: إنها تقوم على فكرة مفادها بأن المعنى لا يحتاج إلى الكثير من اللغو لتوضيحه، لكنه يحتاج إلى ما يعمقه. وفي كثير من الحالات، تكون السخرية هي ما يضيف للمعنى عمقا فوق عمق، ويجعله أكثر تأثيرا وحضورا.
وفي هذا السياق، يقدم مثالا من قصيدة تتناول التفاوض العبثي، الذي نعرفه منذ أكثر من ثلاثين عاما، حيث يعبر المتكلم عن موقف حاسم ومتمرد: "فلتقلب الأرض طاولة التفاوض في وجوه الأغراب، مهما كانت النتائج: "فاوضي أيتها الأرض،/ادخلي في جدول الأعمالِ،/واستفتي العيون،/واقلبي طاولة الأغراب في/لحظة عشقٍ وجنون،/وليكن في آخر الحزن المشظّى/ما يكون". هنا، تختلط العاطفة الثائرة بـالإرادة الوجودية، ويصبح الفعل الشعري أداة رفض، وموقفا من العبث، وتعبيرا عن ارتباط الأرض بالعشق، لا بالصفقات.
وخلص خليل إلى أن المفارقة اللفظية لدى البتيري، تقوم على الجمع بين البهجة والموت، في تناقض يحمل دلالات شعورية عميقة. ففي قصيدة قصيرة بعنوان "راحلة"، يستهل الشاعر المقطوعة بصور العشب المحترق، والوردة الذابلة التي لم تعد تلتفت إليها العيون، ثم يقدم صورة الموت الذي يرافق المتكلم كظله، فيجعل "كاهنة البهجة" تجفل منه وتلوذ بالفرار، ومع ذلك، يؤكد المتكلّم أن هذا الرفيق – الموت – هو خياره، وطريقه: "حين رأتْ كاهنةُ البهجة/
أنّ الموتَ صديقي/جفلت من ظلّي/وبكلّ نضارتها/هربت من وجه طريقي".
وفي قصيدة أخرى بعنوان "تلويحة"، يوحي الشاعر في بدايتها بالقلب الطليق، الذي يخشى عليه من عيون الحاسدين. غير أننا نُفاجأ في نهاية المقطوعة أن هذا القلب مسجونٌ داخل الجسد، لا يملك التحليق، مثل طائر حبيس: "لوّحتْ بالجديلة بنتُ الذينْ/ورمتْ قبلةً في الهواء/فخفتُ على القلب من أعين الحاسدينْ/وحين ركضتُ إليها كطفلٍ وقعتُ/ارتطمتُ بجدران قلبي السجين".
شارك في الندوة، إلى جانب الشاعر، الناقد الدكتور إبراهيم خليل، الذي قدم ورقة نقدية تناولت ديوان "نهر لشجر العاشق"، الصادر بدعم من وزارة الثقافة عن دار الخليج للنشر والتوزيع، وأدارها الدكتور أحمد ماضي أول من أمس، في مقر رابطة الكتاب الأردنيين.
يعد علي البتيري من الأسماء البارزة في الساحة الشعرية العربية، وصاحب تجربة شعرية متميزة، تنبض كلماته بأحلام الوطن، وأوجاعه، وآماله في غد أفضل. واستهل الشاعر البتيري الندوة بقراءة مجموعة من قصائده التي تناولت مدينة القدس والمسجد الأقصى، ومنها: "قلبي على القدس"، "إنها القدس"، "طفل غزي يسأل"، "حنين إلى الأقصى"، "من مذكرة عربي نسي أن يموت"، "نداء الجيل". وفي مقطع قصيدة "قلبي على القدس"، قرأ الشاعر: "قلبي على القدس ما مرَّ الزمان عل قلبي/ولم يرهُ إلا على القدسِ/حبيبتي القدسُ فوق العشق أعشقها/أغلى على النفس في دنيايَ/ من نفسي/أم المدائن نور الله باركها/وكل صبحٍ حكى يا ليتها شمسي/ في العقل ماثلة في الروح والحسن/ الانبياء استر احوا في مداخله/ والفاتحون انبروا بالسيف والتر/يجاهدون وعين الحق شاهدة/على مدى الفرق بين اليوم والام/فاليوم لا صحوة كبرى فتوقظنا".
ومن قصيدة حنين إلى الأقصى" يقول الشاعر في مقطع منها: "أيطيبُ غيشٌ ءأو يروق منامُ/والمسجد الأقصى الأسير يُضامُ؟/ تعوي ذئابُ، الليل في باحاته/ويفيض ظلمٌ حوله وظلامُ/مسرى النبي مطوّقٌ بحواجزٍ/وصلاتُنا بين الحراب تقامُ".
ومن قصيدة نداء الجيل: "الأرضُ أرضي مذ عرفتُ ربوعها/فالقدس روحي والخليل فؤادي/والضفة الخضراء روضة ناظري/وأريج يافا مُنيتي ومرادي/والسلطُ درة موطني في حسنها/ورباك يا عجلون تاجُ وِهادي/أردنُّ أنتَ الماءُ في ظمأ الهوى/وشذى فلسطينَ الحبيبةِ زادي".
ثم قدم الدكتور إبراهيم خليل ورقة نقدية حول ديوان "نهر لشجر العاشق"، للشاعر علي البتيري قال فيها إن الشاعر يكتب الشعر منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، وأصدر عددا غير قليل من الدواوين، ونشر عددا كبيرا من القصائد في الصحف والدوريات، وساهم في العديد من الملتقيات الشعرية، والأماسي، والندوات، سواء على المستوى العربي أو المحلي.
وقد حاز الشاعر غير قليل من الجوائز في مجالات الشعر، وشعر الأطفال، والأغنيات الإذاعية، وهو أمر لا ينكر فضله، ولا يجحد أصله وفصله.
ورأى خليل أن صورة الأب الذي يعشق الزيتون تتسع وتترسخ، لتستوعب الكثير من الآباء الفلاحين الذين يعشقون التراب، والكروم، والسهول، والسفوح، فضلا عن الجبال، والمدى المُزنر بسلاسل من القمم الشوامخ. فهذا الفلاح أب لا يمل الحديث عن عشقه لتلك الشجرة: شجرة الزيتون، وحنوه عليها مثلما يحنو الطير على فراخه في العش. ولا يفتأ يغني للدالية، محترسا حذرا من عيون الأعداء: "وأبي ظل، يرحمه الله،/محترسا من عيون الرياح/تداعت عليه بأكفانها/فلاذ بزيتونة ظللت روحه/واستراح".
وبين خليل أنه في قصيدة "قنديل في الذاكرة" (ص 62)، فنجد البساطة نفسها، واللغة الشعرية ذاتها، التي تنأى عن الخطابة والمباشرة، لتقدم المعنى في صورة لا تحتاج من المتلقي إلا إلى قليل من التأويل. فالجد يخشى أن يموت في منفاه، دون أن يتاح له أن يلقي نظرة الوداع على الوطن الذي أحب: "لا أحب الموت أن يأتي بنومي/مثل لص يرتدي ثوب الظلام/يقبض الروح ويمضي/تاركا جثمان عشقي في المنام/دون أن ألقي بروحي/لحظة الموت على وجه فلسطين السلام".
وأضاف خليل أن هذا النموذج يضاف إلى صورة الأب المتمسك بالزيتون حتى اللحظة الأخيرة. فهو لا يبالي بالموت، ولا يخشاه، ولا يتشبث بالحياة، بل إن الشيء الوحيد الذي يرهبه هو أن يفارق هذا العالم من دون أن يلقي النظرة الأخيرة على وطنه، فلسطين.
ولا يفتأ الشاعر يكرر هذه الصورة للأب الراحل، الذي ترك في نفس الابن الكوابيس عوضا عن الأحلام، إذ غدا بعده يعاني – فوق فراق الوطن – اليتم القلبي. فهو لا يلتقي الأحباب، ولم يعد قادرا على كتابة الشعر، فكأن الإلهام قد جفاه، والوحي يتحاشاه: "مذ مات أبي/صارت أحلامي/بلقاء الأحباب بعيدة/مذ مات أبي/وتيتَّم قلبي/لم أكتب في عينيك قصيدة".
وفي صورة أخرى، تمتد قصيدة السيرة لدى الشاعر في مشاهد تتآلف ولا تختلف، فنجد صورة الأم التي تخشى على ابنها من البرد القارس، فتعلق فوق رأسه معطفا من تراب أبيه الراحل، ويخاطبه طيفها قائلا إنها لم تدع وسيلة من وسائل الوقاية إلا استخدمتها، ولا نوعا من الملابس إلا وألبسته إياه. ولهذا يقول طيف الأم: "تدفّأ،/ترابُ أبيك لروحك ثوبٌ/عليكَ أحنّ،/ولو كنتَ مرتديًا كلّ ما في بلادِ الأسى/من ثياب".
وأشار خليل إلى أن الأم، التي ترمز – في رأينا – إلى الصامدين على تراب الوطن، الذين لم يهجروه، تتساءل عن المغتربين في المنافي: متى يعودون إلى شواطئ العمر التي غادروها منذ زمن؟ فهي، بلا ريب، تتوق مثلهم إلى تلك العودة المعطرة بأريج اللقاء، وعطر المحبّة، والشوق اليقظ الذي لم ينم: "ويمِّم جراحك شطر البحار التي/تستحمّ نجومُ المحبّين فيها/بعطر اللقاء المُذاب".
كما أن الأم بحسب خليل، قد شاخ الشوق في قلبها وهي تنتظر عودة الغائب، بلا جدوى. حتى الأخبار التي كانت تصلها منه أو عنه، أصبحت نادرة، وغابت عنها رسائله، وانقطعت، رغم ما تعانيه، ويعانيه هو الآخر من شوق وحنين: "وأنا ما زلتُ في/شوقٍ لأمّي/وعلى قِمّة أحزاني/أُغنّي".
فمن شدة ما يشعر به المتكلم من شوق، لم يعد يفرق بين اللذة والألم؛ فالغناء هنا ليس تعبيرا عن السعادة، بل بوح بالأوجاع، وصوت قلب مثقَل بالحزن. وهذه المفارقة تعبر عن جوهر التجربة الشعرية لدى الشاعر، وتشبه تلك المفارقة التي تختم بعض قصائده القصيرة.
ففي إحدى قصائد ديوانه "لماذا رميت ورود دمي"، يكتب: "كيف لي أن أصدّق شيخَ الكلام/بعد أن قال لي/وهو يلفظ أنفاسه ويموت:/عاش... عاش... السكوت!".
ويتحدث خليل عن القصيدة القصيرة قائلا: إنها تقوم على فكرة مفادها بأن المعنى لا يحتاج إلى الكثير من اللغو لتوضيحه، لكنه يحتاج إلى ما يعمقه. وفي كثير من الحالات، تكون السخرية هي ما يضيف للمعنى عمقا فوق عمق، ويجعله أكثر تأثيرا وحضورا.
وفي هذا السياق، يقدم مثالا من قصيدة تتناول التفاوض العبثي، الذي نعرفه منذ أكثر من ثلاثين عاما، حيث يعبر المتكلم عن موقف حاسم ومتمرد: "فلتقلب الأرض طاولة التفاوض في وجوه الأغراب، مهما كانت النتائج: "فاوضي أيتها الأرض،/ادخلي في جدول الأعمالِ،/واستفتي العيون،/واقلبي طاولة الأغراب في/لحظة عشقٍ وجنون،/وليكن في آخر الحزن المشظّى/ما يكون". هنا، تختلط العاطفة الثائرة بـالإرادة الوجودية، ويصبح الفعل الشعري أداة رفض، وموقفا من العبث، وتعبيرا عن ارتباط الأرض بالعشق، لا بالصفقات.
وخلص خليل إلى أن المفارقة اللفظية لدى البتيري، تقوم على الجمع بين البهجة والموت، في تناقض يحمل دلالات شعورية عميقة. ففي قصيدة قصيرة بعنوان "راحلة"، يستهل الشاعر المقطوعة بصور العشب المحترق، والوردة الذابلة التي لم تعد تلتفت إليها العيون، ثم يقدم صورة الموت الذي يرافق المتكلم كظله، فيجعل "كاهنة البهجة" تجفل منه وتلوذ بالفرار، ومع ذلك، يؤكد المتكلّم أن هذا الرفيق – الموت – هو خياره، وطريقه: "حين رأتْ كاهنةُ البهجة/
أنّ الموتَ صديقي/جفلت من ظلّي/وبكلّ نضارتها/هربت من وجه طريقي".
وفي قصيدة أخرى بعنوان "تلويحة"، يوحي الشاعر في بدايتها بالقلب الطليق، الذي يخشى عليه من عيون الحاسدين. غير أننا نُفاجأ في نهاية المقطوعة أن هذا القلب مسجونٌ داخل الجسد، لا يملك التحليق، مثل طائر حبيس: "لوّحتْ بالجديلة بنتُ الذينْ/ورمتْ قبلةً في الهواء/فخفتُ على القلب من أعين الحاسدينْ/وحين ركضتُ إليها كطفلٍ وقعتُ/ارتطمتُ بجدران قلبي السجين".











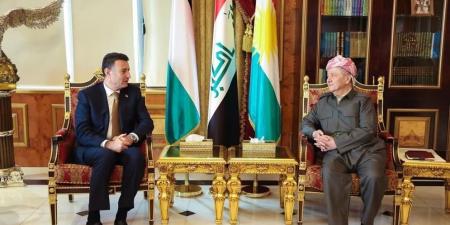
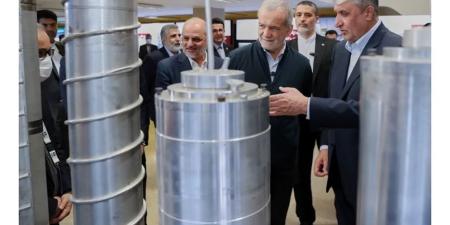




0 تعليق